
✍🏼 بقلم: أحمد الخبراني
كنت أظن أن فاجعة رحيل ابني نايف، رحمه الله، هي الجرح الذي لن يندمل، والصدمة التي لا يواسيها شيء. كنت أعتقد أن الحزن الذي استوطن صدري لا يشبهه حزن، ولا يدانيه ألم. كيف لا؟ ونايف كان النور، والضحكة، وأغلى ما وهبني الله.
وفي أحد الأيام، زرت قبره، كما أفعل كلما ضاقت عليّ الدنيا، لأبثه شوقي، وأحدثه عن غيابه الذي لم أعتده. وهناك، التفتُّ فرأيت رجلًا يزور قبرًا قريبًا من قبر نايف، بدا عليه الحزن جليًّا، ودمعة حائرة تنساب على خده بصمتٍ موجع.
ترددت قليلًا، ثم دفعتني الرغبة الإنسانية للمواساة، أو ربما الفضول الأبوي الذي يبحث عن وجع يشبه وجعه. سألته بلطف: “قبر من هذا الذي تزوره؟”، فأجاب بصوت مكسور: “ابن أخي… كان طفلاً صغيراً .. ثم ”سكت قليلًا، و تابع وكأن الكلمات تختنق في صدره: “اختبأ في شنطة السيارة … ولم ينتبه له أحد إلا بعد فوات الأوان. وُجدناه ميتًا، بعد أن اختنق داخلها.”
تسمرت في مكاني، لم أجد ما أقوله. فقط نظرت في عينيه، وقلت في قلبي: “اللهم صبّر قلبه كما صبّرت قلبي.”
في تلك اللحظة، شعرت أن الحزن لا وطن له، وأن الفواجع حين تتلاقى، تهدأ قليلاً، ويخف وقعها حين نكتشف أننا لسنا وحدنا.
نعم، “من رأى مصيبة غيره، هانت عليه مصيبته”، لكن المقصود ليس التقليل من الوجع، بل الشعور بأننا بشر، نغرق جميعًا في بحر الابتلاء، وكلٌّ يحمل جرحه على قدر قلبه.
رحم الله نايف، ورحم الله ذلك الطفل الذي قضى في عزلته الصغيرة داخل شنطة سيارة. وجعل الله لنا ولأهاليهم في كل فقدٍ صبرًا، وفي كل ألمٍ سلوى، وفي كل دمعٍ أملًا بأن نلتقيهم في دار لا فراق فيها ولا موت.


















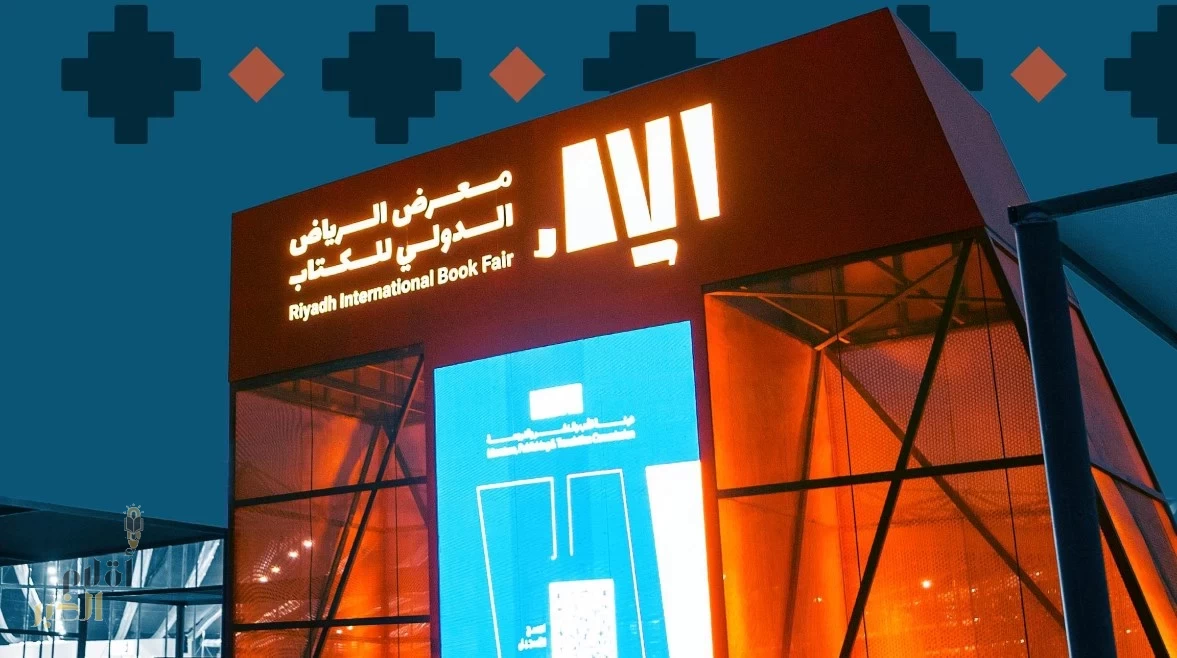








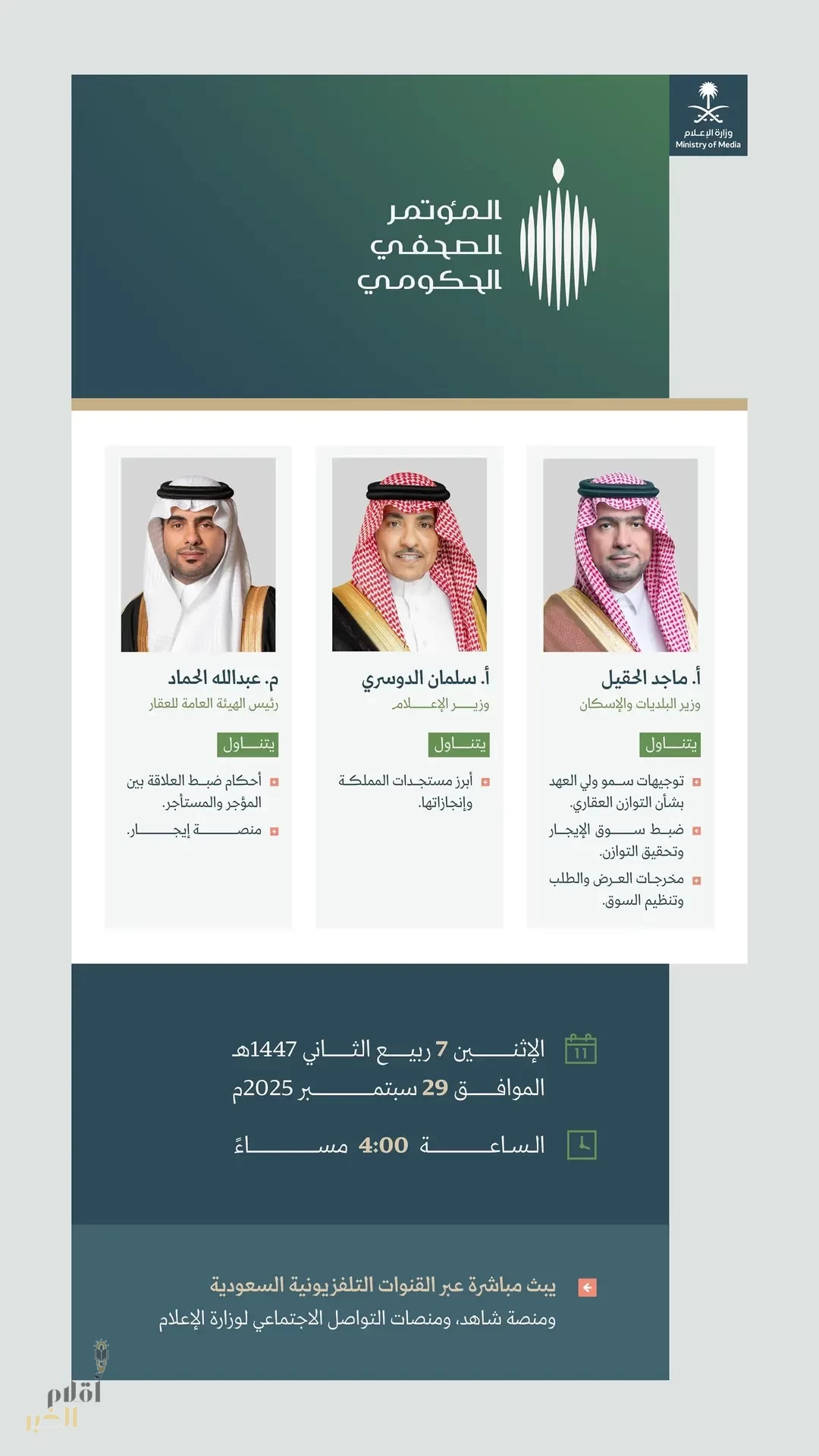



(0) التعليقات
تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات