
في عصر الخميس، لازلت أذكر تلك اللحظة التي حمل فيها ابني نايف الهاتف، وابتسم ابتسامة لا تُنسى، ثم قال بعفويته الجميلة:
“أول مرة أصوّر نفسي عند المسبح… خلوه ذكرى معكم.”
كأن قلبه أحس…
كأن الطفل الذي لا يعرف سوى الضحك، كان يُودّع الحياة بصورة، وصوت، وكلمة.
ضحكنا حينها… ولم نكن نعلم أن هذا الفيديو سيكون كل ما تبقّى منه.
أن تلك الجملة العابرة، ستُصبح… وصيته الأخيرة.
قضى نايف يومه كما يحب…
سبح في المسبح، استمتع بالماء، ملأ الأرجاء ضحكًا ولعبًا، وظل هناك حتى حل الظلام..
ثم خرج، فقلت له: “خلاص،… البس ملابسك.”
لكنه قال بابتسامة صغيرة:
“بس أبغى أسبح سبحة أخيرة.”
لم أكن أعلم أنها ستكون السبحة الأخيرة فعلاً… بل النهاية.
عاد مجددًا، لكنه لاحظ أن الهواء نقص من إحدى الحلقات.
فقرر دون أن نعلم أن ينفخ المسبح بالمنفاخ الكهربائي..
لهونا عنه لحظات بسيطة…
اعتقدتُ أنه لا يزال يضحك ويلهو، كما يفعل دائمًا.
لكنني عدت… لأجد الصدمة.
كان المسبح ساكنًا…
لكن جسد نايف لم يكن كذلك.
ممدد على بطنه، وجهه في الماء، ساكنٌ كأن الزمن توقف من حوله، والمنفاخ ما زال موصولًا بالكهرباء… يهمس بالخطر الذي جئت متأخرًا لسماعه.
صرخت باسمه، وركضت نحوه، حافيًا، على أرض مبتلة…
مددت يدي لسحبه، فإذا بالكهرباء تمزقني، وتطرحني أرضًا.
قمت مرتجفًا، عدت من جديد… لكن التيار دفعني للخلف بعنف،
كأنه يمنعني عن من كنت أظنه “لي”،
كأنه يقول:
“خلاص… انتهى كل شيء.”
حاولت فصل الفيش… فصُعقت.
ركضت بجنون إلى العداد، أطفأته… أظلم البيت.
وصوت أمك إخوتك يتعالى من الداخل:
“وش صار؟! وين نايف؟!”
لم يكونوا يعلمون أن الضوء الذي انطفأ…
كان روح نايف.
عدت إليه… سحبته، احتضنته،
ضغطت على صدره، أنعشته، ناديت، صرخت، توسلت…
لكن لا نبض، لا نفس، لا استجابة.
حملته وركضت به إلى المستشفى،
وكلّي رجاء… أن يقولوا: “لحقناه.”
لكنهم خرجوا بوجوهٍ لا تُبشّر بشيء،
وقالوا لي بجفافٍ صاعق:
“البقاء لله… نايف فارق الحياة.”
مات نايف…
وانكسر شيء لا يُرمم بداخلي.
ومنذ تلك اللحظة، وأنا أعيش مع سؤال لا يغيب:
“ليش ما متّ معه؟”
أنا الذي صُعقت،
أنا الذي لمسته،
أنا الذي قاتلت التيار لأحمله…
فلماذا بقيت، وهو رحل؟
لم أمت معه…
لأن الله أراد أن أكون الشاهد،
أن أروي، أن أُحذر، أن أُبقي صوته حيًا في هذه الدنيا.
لم أمت معه…
لأن نايف ختم حياته بكلمة لا تزال ترنّ في أذني:
“خلوه ذكرى معكم.”
فها أنا يا نايف…
أبقيك في قلبي، في صوتي، في وجهي، في كل كلمة أكتبها…
وفي كل مرة أهرب من نومي لأن الذكرى أثقل من الحلم.
************************************
واليوم… هذه هي الجمعة الثالثة بدونك.
كنتَ أول من يصحو في هذا اليوم، متعطرًا، متطيّبًا، بثيابك البيضاء، جاهزًا لصلاة الجمعة قبل الجميع.
كنت توقظني بحنان، تسبق إخوتك للوضوء، وتملأ البيت نورًا.
واليوم…
أصحو فلا أراك.
أدخل المسجد، وأنظر بجانبي… فلا أجدك.
أسمع الخطبة وكأنها نواح،
وكل جمعة تمر… يتكرر الفقد من جديد.
لم أمت معك…
لكنني أعيش موتك في كل فجر،
وأدفن حلمي بك في كل جمعة.
⸻
رحمك الله يا نايف…
يا أول من ودّعني دون أن يلتفت.
يا آخر من ابتسم… وهو لا يعلم أن السيلفي الذي التقطه،
سيكون المعلّقة التي لن تُمحى من جدار قلبي.
لم أمت معك…
لكنني أموت بك،
كل يوم، ألف مرة.
✍️ لستُ أنا من كتب،
بل هو قلمي الذي ارتجف،
وقلبي الحزين الذي نزف..


















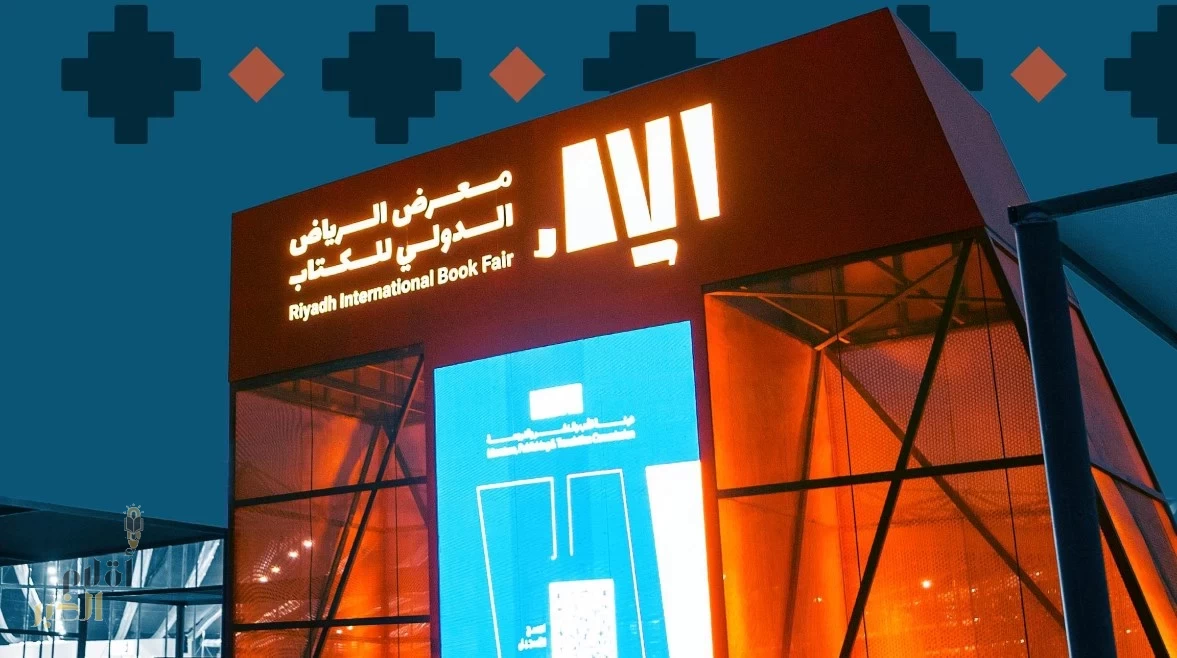








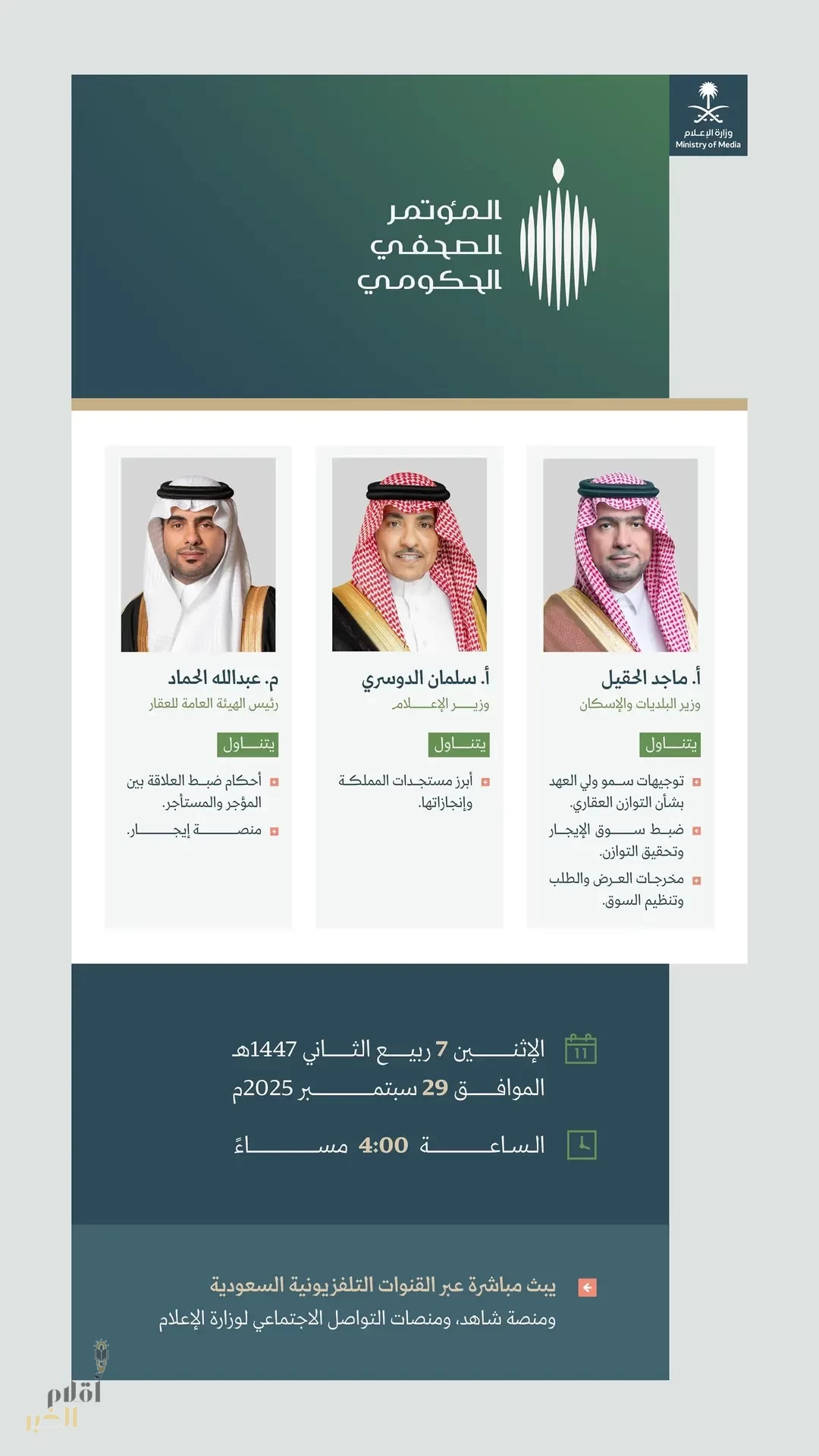



(0) التعليقات
تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات